ومن الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، عياناً بأبصارهم، من غير إحاطة، في موضعين: أحدهما: في عرصات القيامة، أي مواقف الحساب. والثاني: بعد دخولهم الجنة، قال تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ )
وقال: ( عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ)
وقال: ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ)
.jpg)
.jpg)
وقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم
وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته))
وقد ضل في هذا الباب طائفتان:
أحدهما: نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من الرافضة والإباضية: فقد أنكروا الرؤية واستدلوا بقوله تعالى لموسى: (لَن تَرَانِي)
.jpg)
وقوله تعالى: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ)
والرد عليهم: أن المراد بقوله: (لَنْ تَرَانِي)
أي: في الدنيا كما طلب، ولا يلزم من (لن) النفي المؤبد، وأن نفي الإدراك نفي للإحاطة لا نفي للرؤية، فقد تقع الرؤية ولا يقع الإدراك، كما في رؤية الشمس، والقمر، والجبل، ونحوها. مع تواتر النصوص القرآنية والنبوية على إثبات الرؤية.
الثانية: الخرافيون من الصوفية والمبتدعة: الذين غلوا في إثبات الرؤية وسوغوا وقوعها في الدنيا لأوليائهم ورووا في ذلك الأحاديث الموضوعة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ((وأعملوا أنكم لن تروا ربكم -عز وجل- حتى تموتوا))


1- الإيمان قول وعمل؛ قول القلب، واللسان، وعمل القلب، واللسان، والجوارح. فقول القلب: اعتقاده، وتصديقه، وقبوله. وقول اللسان: الاستعلان بالشهادتين.
وعمل القلب: ما يقوم به من النيات، والإرادات؛ كالمحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل.
وعمل اللسان: ما يلهج به من الذكر، والدعاء، والتلاوة.
وعمل الجوارح: ما تتحرك به الأعضاء من العبادات البدنية.


قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ )
وقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)
وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون، شعبة؛ فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان))
فالإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، فهو تصديق مستلزم للقول والعمل، فانتفاء القول والعمل دليل على انتفاء التصديق.
2- والإيمان عند الانفراد، مرادف للإسلام عند الانفراد، فإن كلاً منهما يعني الدين كله، وأما عند الاقتران، فالإيمان يعني الاعتقاد الباطن، والإسلام يعني العمل الظاهر، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، قال تعالى: ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَـٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
3- والإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالعلم بالله، والتفكر في آياته الكونية، والتدبر لآياته الشرعية، وفعل الطاعات، وترك المعاصي، وينقص بالجهل بالله، والغفلة عن آياته الكونية، والإعراض عن آياته الشرعية، وتضييع الطاعات، واجتراح السيئات، قال تعالى: (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا )
وقال: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)
وقال: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ)
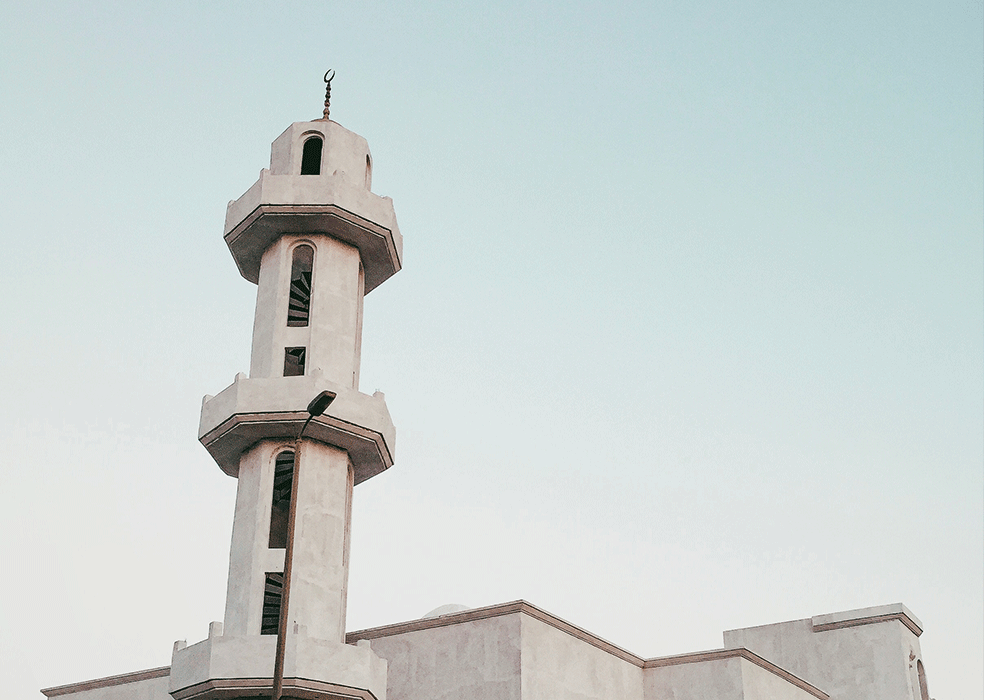
4- والإيمان يتفاضل، وبعض خصاله أعلى من بعض، كما في الحديث المتقدم: ((الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون، شعبة؛ فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان))
5- وأهله فيه متفاضلون؛ بعضهم أكمل إيماناً من بعض، كما قال تعالى: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ)
وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً))
فمن أتى بالشهادتين معتقداً معناهما ملتزماً مقتضاهما، فقد أتى بأصل الإيمان، ومن فعل الواجبات، وترك المحرمات، فقد أتى بالإيمان الواجب، ومن فعل الواجبات، والمستحبات، وترك المحرمات، والمكروهات، فقد أتى بالإيمان الكامل.
6- والاستثناء في الإيمان؛ بأن يقول: "أنا مؤمن إن شاء الله" له ثلاثة أحوال:
أحدها: إن قاله شاكاً في أصل الإيمان، فالاستثناء محرم، بل كفر؛ لأن الإيمان جزم.
الثاني: إن قاله خوفاً من تزكية النفس بادعاء تحقيق الإيمان الواجب أو الكامل، فواجب.
الثالث: إن قاله تبركاً بذكر المشيئة، فالاستثناء جائز.

.jpg)
7- ولا يزول وصف الإيمان بمطلق المعاصي والكبائر، بل تنقصه، مع بقاء أصله. فمرتكب الكبيرة مؤمن، ناقص الإيمان؛ مؤمن بإيمانه، فاسقبكبيرته، لا يخرج من الملة في الدنيا، ولا يخلد في النار في الآخرة، بل يكون تحت المشيئة؛ إن شاء عفا الله عنه، وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة، أو ببعض ذنبه، فيخرج بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)
.jpg)
وقال-صلى الله عليه وسلم-: ((يَخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويَخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويَخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن ذرة من خير)) وفي رواية: ((من إيمان)) مكان ((من خير))
وقد ضلَّ في هذه المسألة طائفتان:
الأولى: الوعيدية: القائلون بإنفاذ الوعيد، وإنكار الشفاعة في حق مرتكبي الكبائر، من عصاة الموحدين، وهم صنفان:
1- الخوارج: القائلون بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، ودخل الكفر، فهو كافر في الدنيا، خالد في النار في الآخرة.
2- المعتزلة: القائلون بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا؛ لا مؤمن ولا كافر! خالد في النار في الآخرة!
والرد على الوعيدية من وجوه، منها:أولاً: أن الله تعالى أثبت الإيمان، وأبقى وصف الأخوة الإيمانية لمرتكب الكبيرة، في الدنيا، كما في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)
فسمى القاتل أخاً للمقتول، وكما في قوله: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّـهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾)
فنسب الطائفتين المقتتلتين إلى الإيمان، وأثبت لهما أخوة الإيمان.
ثانياً: أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، ويُخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما تواترت بذلك أحاديث الشفاعة. الثانية: المرجئة: القائلون بإرجاء الأعمال، أي: تأخيرها، عن مسمى الإيمان، فالعمل عندهم لا يدخل في تعريف الإيمان وحقيقته، وهم في تعريف الإيمان أصناف:
1- الجهمية: تصديق القلب، أو معرفة القلب، فقط، فلا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
2- الكرامية: نطق اللسان فقط
3- مرجئة الفقهاء: تصديق القلب، ونطق اللسان، فقط، وأما الأعمال فليست داخلة في حد الإيمان وحقيقته، بل هي من ثمراته.
والرد على المرجئة من وجوه، منها:
أولاً: أن الله سمى الأعمال إيماناً، فقال في شأن من صلوا إلى بيت المقدس، وماتوا قبل تحويل القبلة: (وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ)
ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفى الإيمان المطلق عن مرتكب الكبائر العملية، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
ومنشأ فساد مقالة كلا الطائفتين؛ الوعيدية والمرجئة من اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله، أو يعدم كله، فأما المرجئة فأثبتوه بمجرد الإقرار بالقلب، أو اللسان، أو بهما معاً، ولو لم يعمل ألبتة، فهم أهل تفريط، وأما الوعيدية فنفوه بأدنى كبيرة، فهم أهل إفراط، فمقدمتهما واحدة، ونتيجتاهما متضادتان!